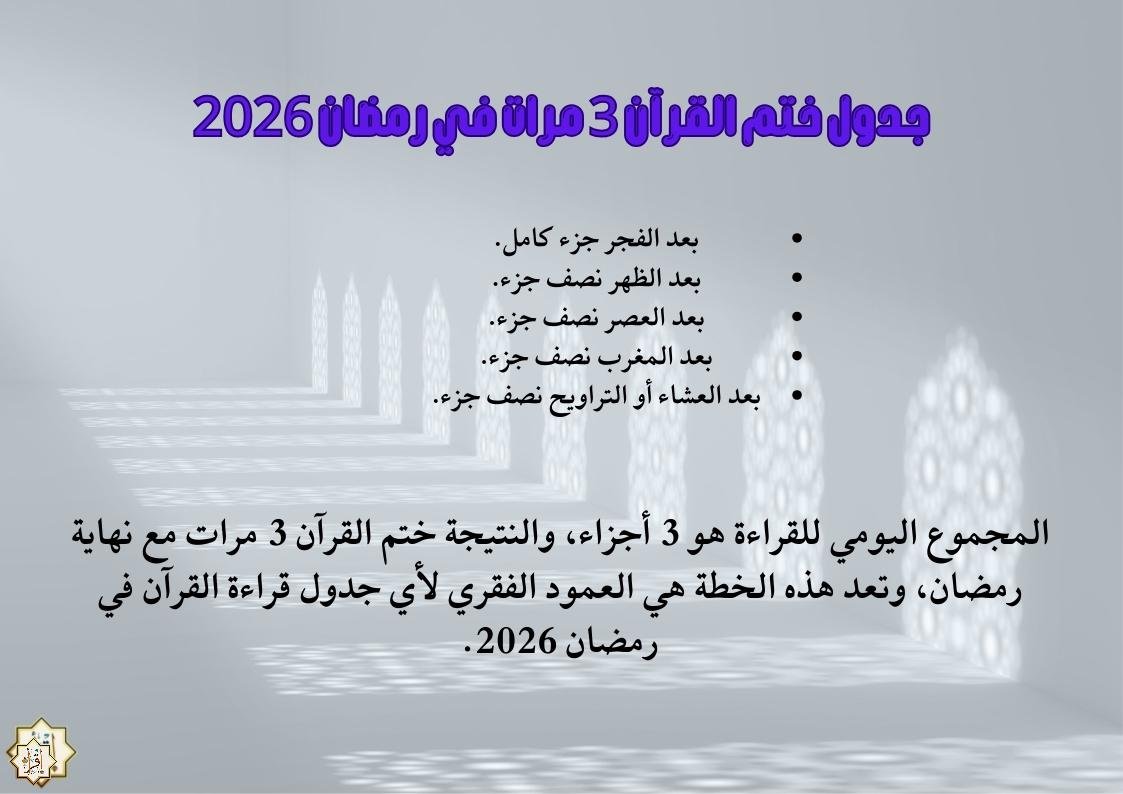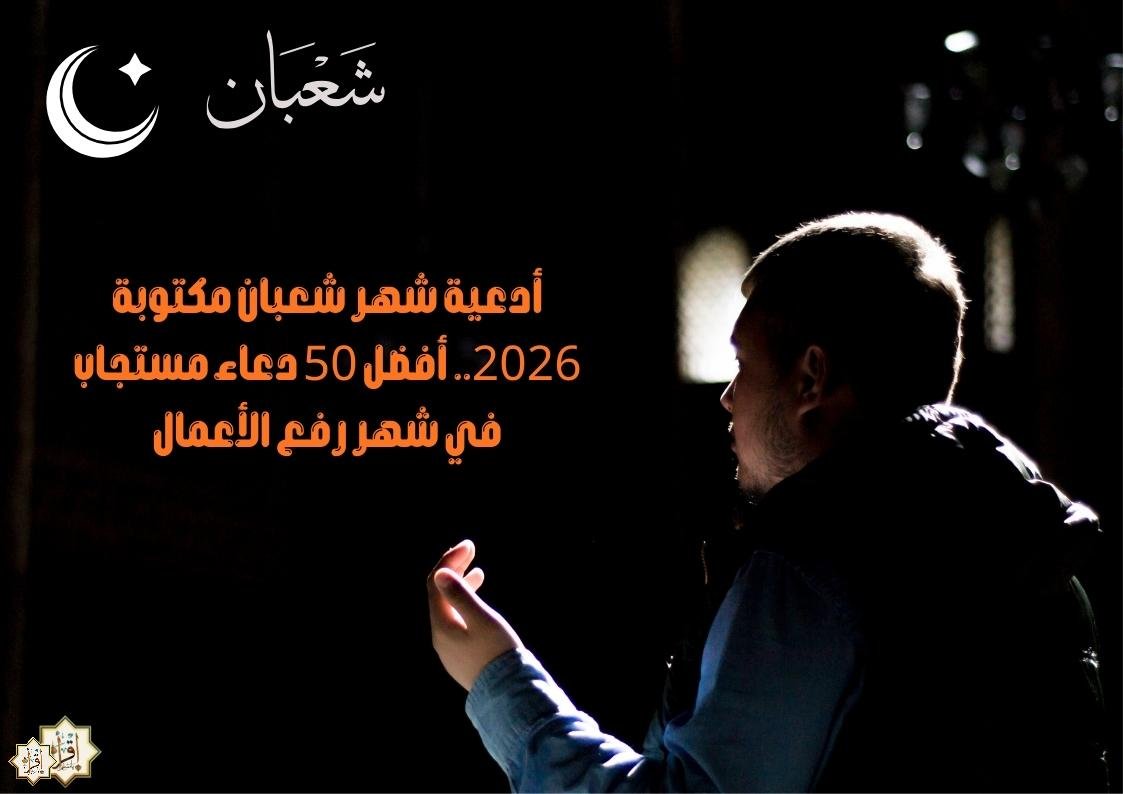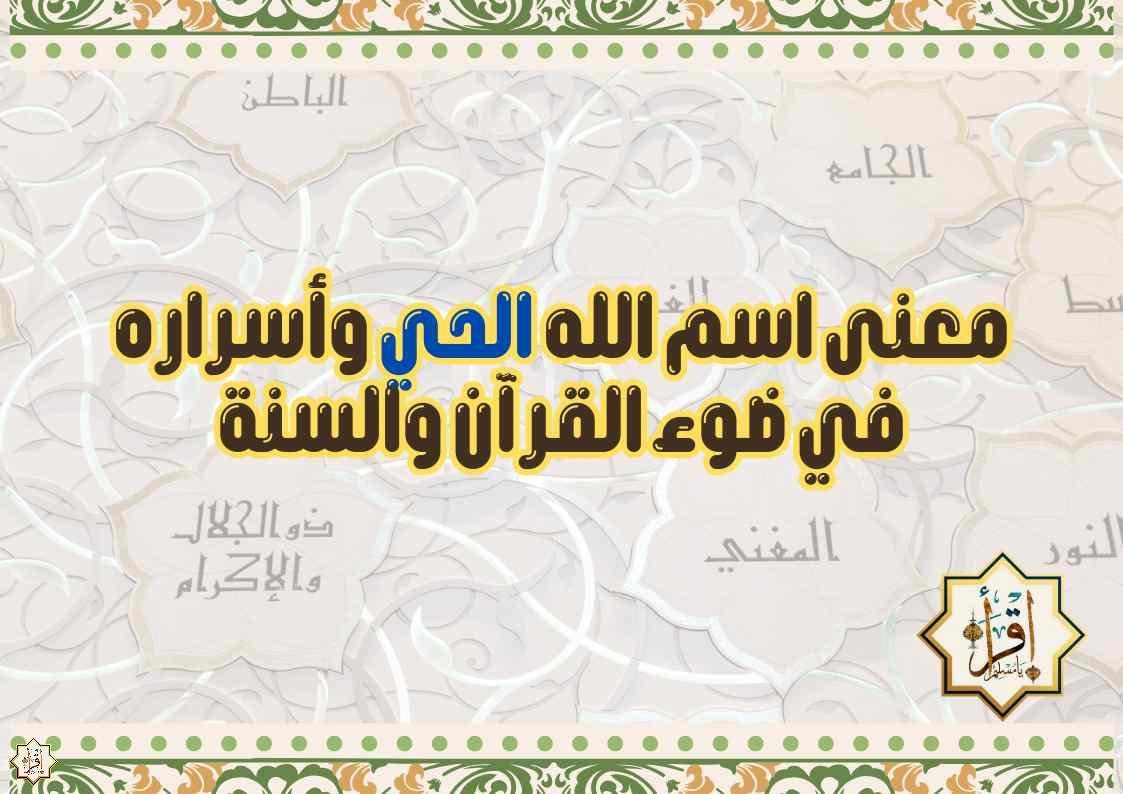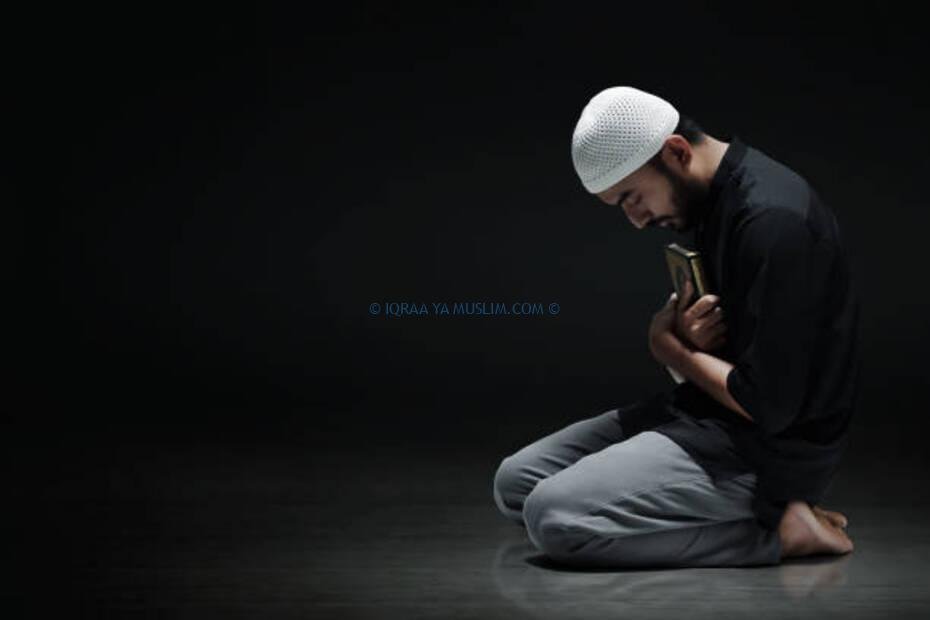لماذا كان العلماء هم اكثر الناس خشية لله؟
حين تشرق أنوار العلم في قلب المؤمن تتبدَّل رؤيته للحياة والآخرة، فيرى بعين البصيرة ما لا يراه الغافلون، ويشعر في أعماق روحه بثِقَل الأمانة التي حمَّلها الله له، فيرتجف قلبه إجلالًا لعظمة الخالق، وتخشع جوارحه رهبةً من مقامه، ولذلك كان العلماء بحق أكثر الناس خشيةً لله؛ لأنهم عرفوه حق المعرفة، فأدركوا جلاله وكماله، وعلموا أن الطريق إليه محفوف بالمحاسبة الدقيقة، وأن كل نفس يتردد في الصدر إنما هي نعمة تُسأل عنها، وعهد يُحاسَب عليه، فالخشية ليست خوفًا يثقل القلب، بل نورًا يقوده إلى الطاعة، وحصنًا يمنعه من المعصية، وهبةً لا ينالها إلا من ذاق طعم العلم الصادق.
لماذا كان العلماء هم اكثر الناس خشية لله؟
القرآن الكريم يرشدُنا صراحةً إلى علاقة العلم بالخوف، ففي قوله تعالى في سورة فاطر: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» لم يقل: «الفقراء» أو «الأغنياء»، بل سمَّى العلماءَ خصوصًا لأنَّ العلم يجعل النفوس تدركُ عظمةَ الله وحقوقَه، وهذا المعنى تبرَّأ له المفسرون وبيَّنوه بأنَّ من يعرف الله ويعلم آياته وحقوقه، تنبع منه خشية حقيقية لا كمسألة ظاهرية أو خوف سطحي.
فجاءت كلمة “إنما” أداة حصر، أي أن الخشية الحقيقية الكاملة لا تكون إلا عند العلماء، وقد فسَّر ابن كثير هذه الآية بقوله: “إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم الموصوف بصفات الجلال والعظمة أتمّ، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر”.
والرسول ﷺ يربطُ بين النعمة وافتتاحِها بالقَلبِ والفعْلِ: «مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، فأهل الفهم في الدين يُمنَحون علمًا يقودهم إلى الوعي، والوعيُ يقودُ إلى الحساب، والحسابُ إلى الخشية، وهذا الحديث الثابت في صحيحَي البخاري ومسلم يؤكد أنَّ الفقه والوعي هبةٌ مرتبطة بمشيئة الله، وأنها سبب في تقوى القلب وإجلالِه.
وليس هذا فحسب، فالقرآن يفرِّق بين من يَعلَم ومن لا يَعلَم: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» (سورة الزمر، الآية 9)، أي العلمُ يُحدث فرقًا في موقف الإنسان من الحقِّ وإدراكِه لنتائجِ الأعمال.
ما الفرق بين الخوف والخشية والرجاء؟
-
الخَوْف: شعور عام بالرهبة من العقوبة أو الأذى.
-
الخِشْية: أرفع؛ هي رهبةٌ مرافقَةٌ للمحبةِ والهيبةِ، واحترام للذات الإلهية يجعل القلبَ رقيقًا ويحبُّ الطاعة.
-
الرَجاء: يقابِل الخوفَ، وهو أمل رحمة ومغفرة من الله.
أصحابُ العلمِ الحقيقيِّ يوازنون بين الخشية والرجاء، فالخشية تدفع إلى الاجتهاد والتورع، والرجاء يدفع إلى الاستمرار والأمل، وهذا التوازن نفسه ذكره علماء الطريقِوالفقهاء أن الخشية فرعٌ من العلم، والازديادُ في المعرفة يؤدي ازديادًا في الخشية، وقال ابن القيم: «كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف»، وهذا بيانٌ لِعلاقة نفسية وروحيةٍبين المعرفةِ والوجل.
لماذا العلماء أكثر خشية لله؟
-
معرفتهم بجلال الله وعظمته، فالعلماء يتأملون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويعرفون معانيها وحقائقها، فيدركون أن الله قويٌّ عزيز، رحيمٌ غفور، شديد العقاب، سريع الحساب، وهذه المعرفة تزرع في قلوبهم رهبةً عظيمة لا يعرفها من جهل هذه المعاني.
-
إدراكهم لحقيقة الآخرة، فالعالم يقرأ النصوص، ويتدبر الآيات التي تصف أهوال يوم القيامة، ونعيم الجنة، وعذاب النار، فيعيش هذه المشاهد في قلبه قبل أن يراها بعينه، فيخشى أن يقف بين يدي الله وهو مقصر.
-
إحاطتهم بحدود الله، فالعلماء يعلمون ما أحل الله وما حرم، وما يجوز وما لا يجوز، فيتجنبون الشبهات قبل الحرام، ويحذرون من الصغائر قبل الكبائر، لأنهم يعرفون أن الصغيرة مع الإصرار تتحول إلى كبيرة.
-
تحملهم لمسؤولية البيان، فالعلماء ليسوا أفرادًا عاديين، بل هم ورثة الأنبياء، يحملون أمانة تبليغ الدين، وتصحيح المفاهيم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأمانة تجعل قلوبهم دائمًا بين الخوف من التقصير، والرجاء في القبول.
-
بصيرتهم بأثر الذنوب، فالعلماء يدركون أن الذنب ليس مجرد فعل ينتهي، بل له أثر على القلب، وعلى المجتمع، وعلى البركة في العمر والرزق، وهذا الإدراك يزيد من خشيتهم وحذرهم.
-
موازنتهم بين الرجاء والخوف، فالعالم الحق لا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمته، بل يوازن بينهما، وهذه الموازنة تولد خشية مستقيمة.
-
العلم يُعرِّفُ القلبَ بنقصِ العمل أمامَ عظمةِ الله، فكلما زادت المعرفةُ بعظمةِ الله وكمالِ صفاته، صارَ العبدُ يرى قصورَه أمام هذا الكمال؛ وهذه الرؤيةُ مُرَّةٌ لكنها تُولِّد خشيةً توبةً وتجديدًا.
-
العلم يكشفُ الآثار البعيدة للأفعال، فالعالمُ يرى أن لكل فعل أثرًا في الدنيا وفي الآخرة، في المجتمع وفي قلبِ الدارس، وهذه البصيرة تجعل الخوفَ من الخطأ أعمق لأن العالِم يشعر بأن خطأه لا يخصُّه وحده.
-
العلم يولِّدُ محاسبةً داخليةً أعظمَ، فالمعرفةُ جلسةُ نفس صارمة «هل أنا عاملٌ بما أعلم؟ هل أخافُ ذواتِ الناس؟ هل أُخفي الحقَّ؟» المساءلةُ الذاتيةُ تنتج خشيةً حقيقيةً.
-
من عرف الله أحبَّه وخافَه معًا، كما قال السلف: معرفةُ الله تَشكِّلُ محبّةً وخشيةً وحياءً؛ فالعالمُ إذ يعرف أسماءَ الله وطقوسَ رحمته وفي الوقت نفسه يقِفُ على قدرِ جزاءٍ وعقوبةٍ يصبح أكثر خضوعًا ورهبةً.
- العالمُ الحق يمقِتُ التعالي، فمن دخل في ساحاتِ العلم الحقيقي يرى كم هو محدود، فيزداد حياءً وخشيةً بدلاً من استعلاءٍ متصنِّع.
الفرق بين خشية العالم والناس العامة
خشيةُ العامَّة قد تكون ردَّ فعلٍ لحادثٍ أو نصيحةٍ؛ أَمَّا خشيةُ العالم فهي ثمرُ إدراكٍ دائمٍ، تجلَّاتُها في الاستغفار الكثير، والبكاء على الخطأ، والتحفُّظ في القول والعمل، والاهتمام بالمحافظة على نقاء العلم من الرياء.
العلماء الحقيقيون لا يخشون الخشيةَ التي تُطفِئ الرجاء؛ بل يخشون خوفًا يدفعهم إلى العمل والإنابة، واعلم أن النبي ﷺ قال: «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيةً»، وهذا معنى أن من له علم حقيقي يكون أشد خشية وأعظم حرصًا.
آثارُ خشية العلماء على المجتمع
الخشيةُ لدى العلماء ليست عاطفةً شخصيةً فقط، بل لها أبعاد اجتماعية عظيمة:
-
تقي الأمة من الانزلاق إلى الغلو أو التطرف أو الإهمال الشرعي.
-
تولِّدُ منهجَيةً في التربية والتعليم، فالعلم يتحول إلى سلوكٍ قبل أن يكون مجرد معلومات.
-
تقود إلى تواضع العلماء أمامَ المحتاجين وإلى الاهتمام بالأخلاق إلى جانب الأحكام.
-
تجعل العلماءَ مركز محاسبة روحي ونِدًّا أخلاقيًّا للسلطان والمجتمع.
مناهج لِنسلكَ طريق العلماء: كيف نرتقي بخشيةٍ مُثمِرة؟
إذا أردنا أن نقتدي بالعلماء في خشيتهم (لا أن نحسدهم على ذلك)، فإليك خطوات عملية متدرجة:
- طلب العلم النافع، وابدأ بالعلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والأخلاق، فالعلم الذي لا يورِّث عملًا يقود إلى غرورٍ لا خشية، فالنبي ﷺ قال: «مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ».
- التدبر في أسماءِ الله وصفاته والتأملْ في أسماؤه الحسنى، فالمعرفة هنا تقرِّب القلب وتحقِّق الخشية (وقد توسع ابن القيم والغزالي في هذا المعنى).
-
مراقبةُ النفس ومحاسبتها، فاجعل لنفسك دفتر محاسبة يوميًّا؛ واطلب العفو بسرعةٍ ولا تبرر الخطأ.
-
الصحبة الصالحة وطلب النصيحة، واحضر مجالس العلم عند العلماء العاملين؛ فإن الأقوال تُجسَّد في السلوك عندهم.
-
العمل بالعلم، واجعل علمك عمليًا لا تبتغِ الرياء ولا تَحمل العلم زينةً، فالغايةُ أنْ يكون العلم سببًا في خشيةٍ وروحٍ متفاعلة.
-
التسامح والرحمة، فخشيةُ العلماء لا تعني قسوة؛ بل رحمة وانكسار أمامَ الفقير والخطَّاء.
🔴 العلم الذي لا يولد خشية قد يكون وبالًا على صاحبه؛ لأنه حجة عليه يوم القيامة، وقال سفيان الثوري: “إنما يُطلب العلم ليُتقى به الله، فإذا كان غير ذلك فهو وبال على صاحبه”، كما أن العلمُ إن لم يُرافق بالعملِ والإخلاصِ يصبح سببًا للضلالةِ أو الكبر، وقال أحد السلف: “من تعلم العلم ولم يعمل به كمن لم يتعلمه” وههنا تقعُ المسؤوليةُ الكبرى على العالم أن يجعلَ علمَه بابًا للتواضعِ والخشوعِ، لا للتعاظمِ والتكبر.
في الختام، تعرفنا لماذا كان العلماء هم اكثر الناس خشية لله؟، ووجدنا أن العالِمُ الحقيقيُّ هو الذي أحسَّ قبل أن يعلِّم، والذي بكى قبل أن يفتِّي، والذي خافَ قبل أن يُعلِّمَ الناس الثقةَ والاطمئنان، فالخشيةُ عنده ليست ضعفًا، بل عنوانُ قوَّة معنوية؛ قوّة تُنقِذ الأمةَ من الضياع وتُعيد إليها توازنها، وإن أردنا أمةً تقفُ على قدميها، فليكن علماؤها أوَّلَ الناسِ خشيةً لله، ولتكن المدارسُ الدينيةُ بؤر تربية قبل أن تكون مخازن معلومات.
فلنطلب العلمَ متواضعين ونعمل به متخشعين ونعلِّمَه مصدَّقين ونترك أثرًا لا مجرد كلامٍ، فكم من طالب علمٍ إذا عرف قدرَ الأمر خَشِعَ قلبُه وتبدَّلت طريقة حياته، وهذا حلمُ الشريعة أن يثمر العلمُ خشيةً صالحةً تحفظُ المجتمع وتُقَرِّبُ العبدَ من خالقه بصدقٍ وأمانة.
المصدر