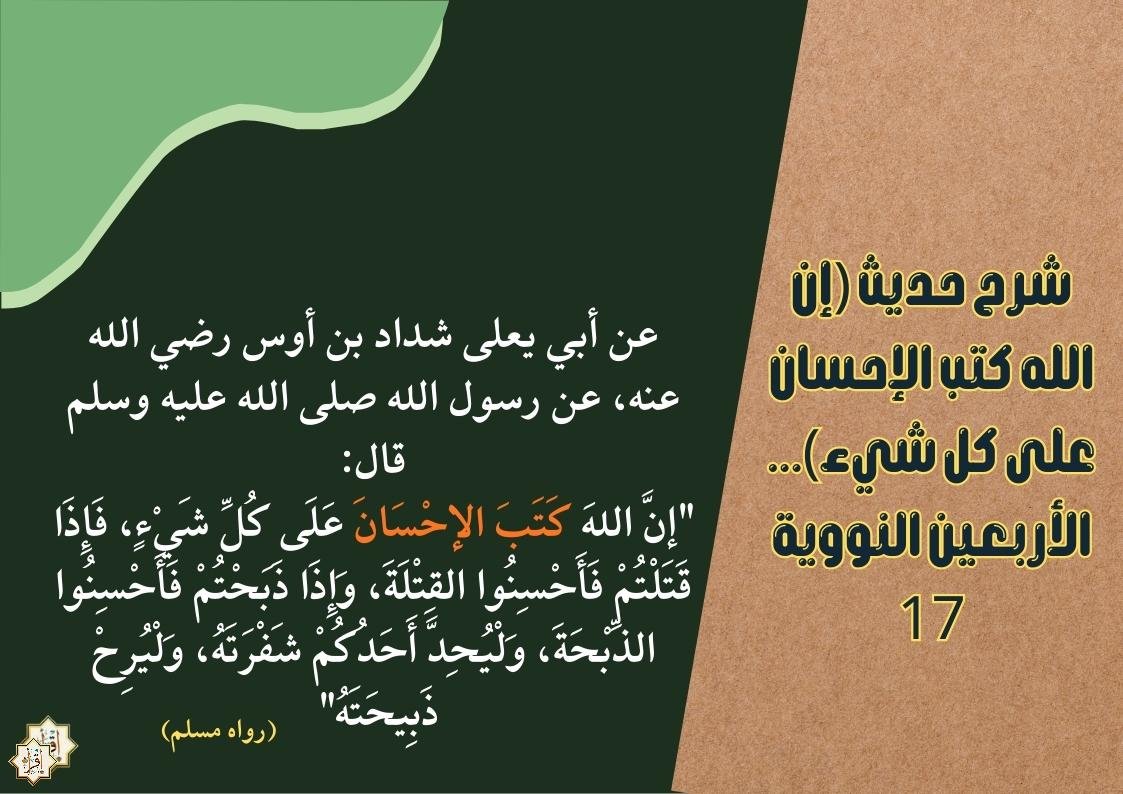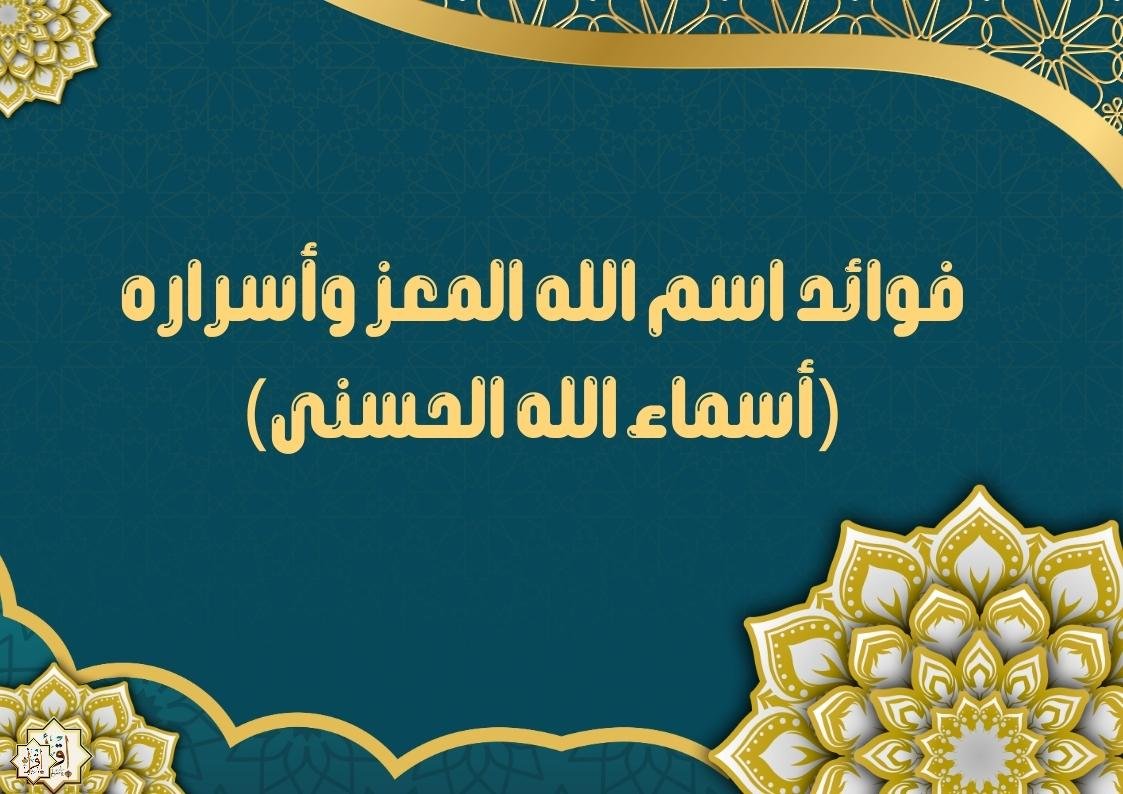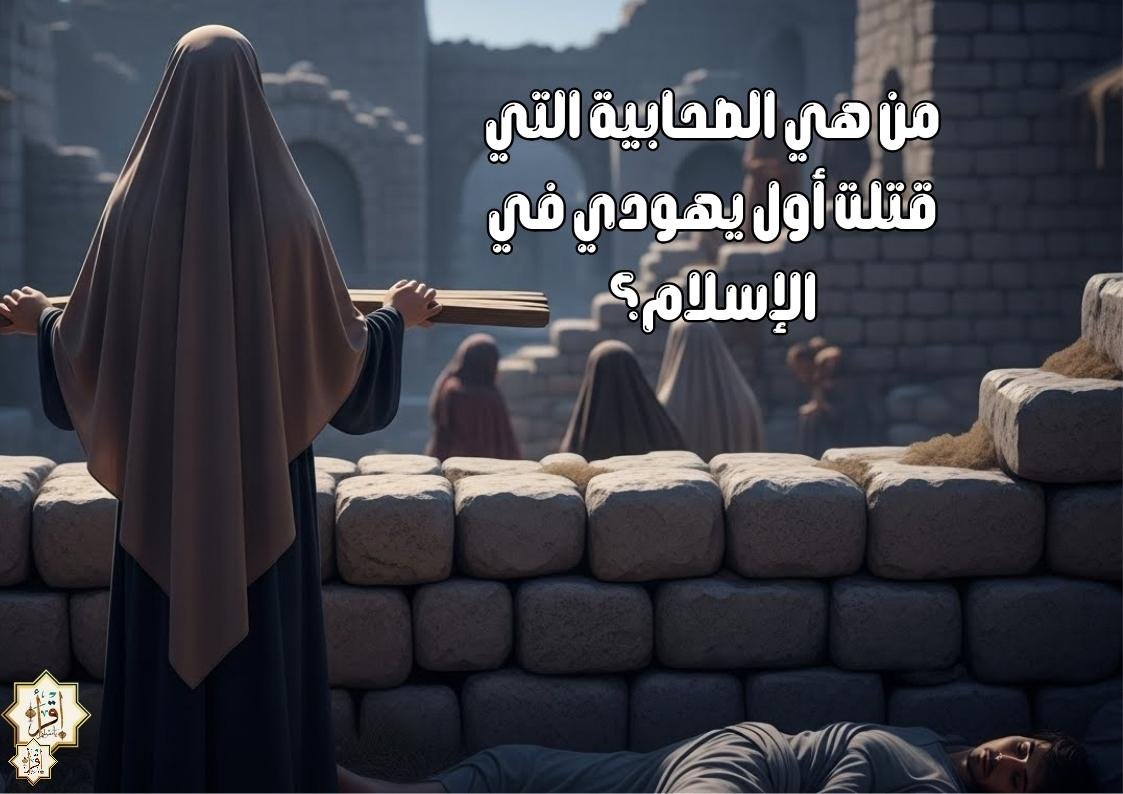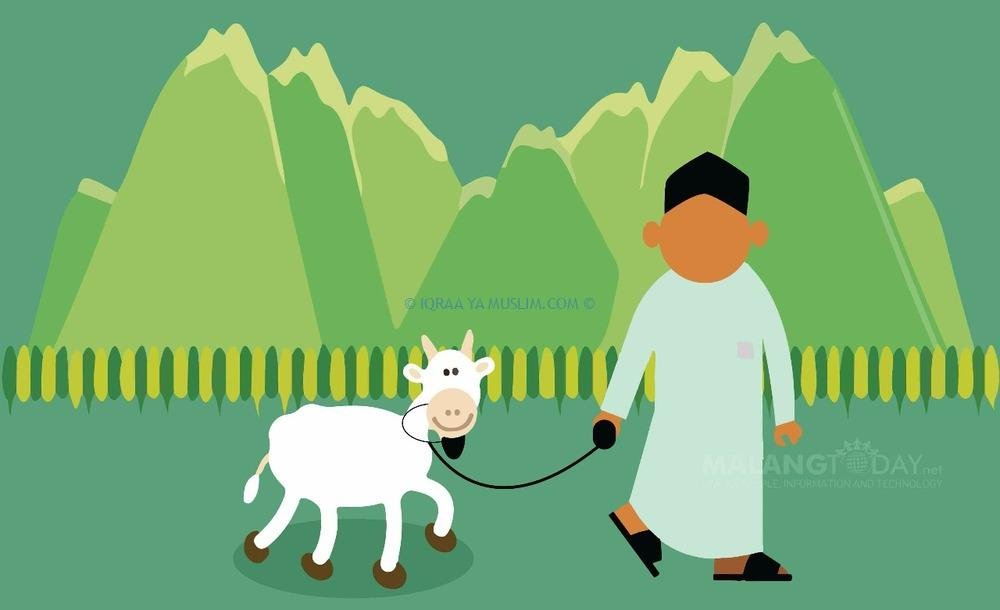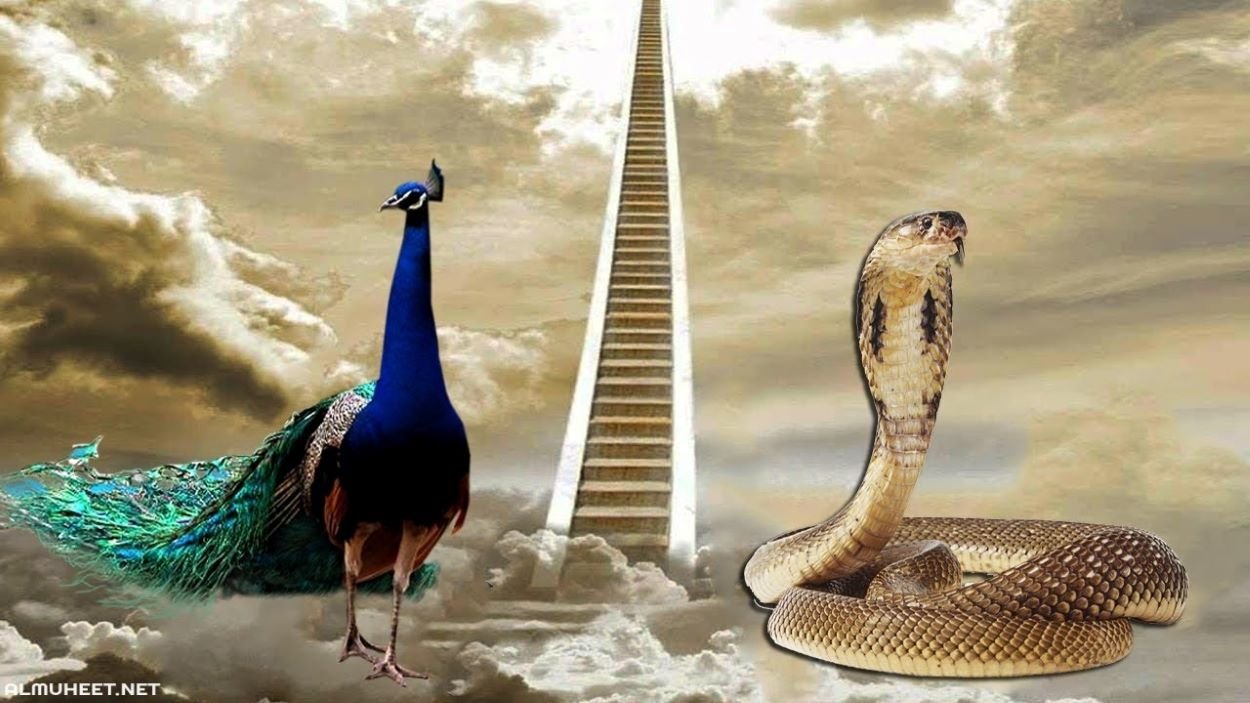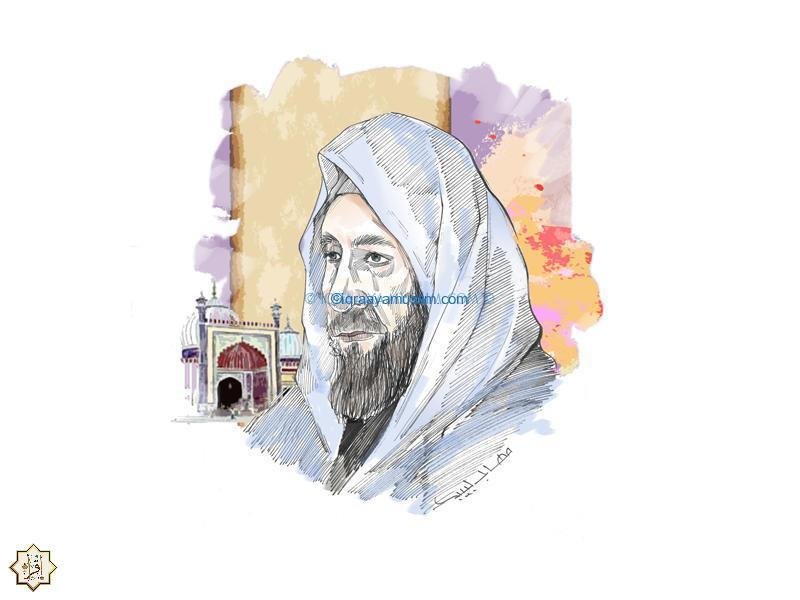الطبيعة في القرآن الكريم (تجليات القدرة الإلهية وآيات ربانية ناطقة)
تأملات في عظمة الخالق من خلال آيات الطبيعة في القرآن الكريم

حين يفتح المؤمن مصحفَه بعين المتدبِّر يرى الكون يفتح له أبوابه سماءً بلا عمد، وأرضًا ممهدة، وجبالًا راسيات، وبحارًا تمور، ورياحًا تلقِّح، ونباتًا يخرج من بين صلب التراب، وليلًا يلف الوجود بردائه، ونهارًا يبسط الرزق والحِرَف، والطبيعة في القرآن الكريم ليست خلفية صامتة؛ بل خطاب ربَّاني حي يسوق الله به القلوب إلى معرفته ومحبتِه وخشيته.
قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [سورة آل عمران، الآيتين 190–191].
سنقدم في هذا المقال تأمل وتدبر لآيات الطبيعة في القرآن الكريم، والتي من خلالها نتعرف على قدرة الله في خلقه وحكمته وإعجاز القرآن الكريم.
الطبيعة في القرآن الكريم
يصف القرآن الكريم المشاهد الكونية بلفظ «الآيات»، لا «الظواهر»، والفرق جوهري؛ فالآية علامة دالَّة على المتكلِّم سبحانه توقظ العقل والقلب معًا، فالله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [سورة فصلت، الآية 37]، وقال: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سورة فصلت، الآية 53].
علَّق الطبري على آيات الطبيعة في القرآن الكريم بأن الله يلفت أنظار العباد «إلى دلائل ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وفي الآفاق»، ويذكر ابن كثير أن تكرار لفظ «الآيات» مقصوده تثبيت اليقين بربٍّ حكيمٍ عليم.
وحين نتدبر آيات القرآن الكريم وخاصة آيات الطبيعة في القرآن الكريم هناك ثلاثية للتدبر وهي:
-
التفكُّر: نظر عقلي في الدلالة (أَلَا يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الأعراف، الآية 184].
-
التذكُّر: حضور قلبي للعظة (لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) [سورة النحل، الآية 13].
-
الشكر: عمل وانقياد (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا) [سورة سبأ، الآية 13].
فالطبيعة في الميزان القرآني «تُعرّف وتُزكّي وتُكلّف».
يقول الله تعالى: ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ * ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ ﴾ [سورة الملك، الآيتين 3–4]، ويقول عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [سورة الأنبياء، الآية 32]، وفسر القرطبي «محفوظًا» أي «محروسًا من الشياطين بالشهب، ومن الانهدام إلا بإذنه»، والآيات تُربِّي في القلب إجلال النظام الكوني وعدم الاغترار بطول الأناة، وأن هذا السقف المرفوع آية أمان ورحمة، وهو قادر على أن يطوي ما وسِع.
ومن بديع البيان الرباني اقتران السماء بـالميزان: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ [سورة الرحمن، الآيتين 7–8]، والرازي علَّق على هذه الآية وقال: كما أن السماء مرفوعة بلا عماد، فالعدل مرفوع في القلوب ليُصلح أحوال الأرض؛ فمن أخل بميزان الحق أفسد ميزان الكون في محيطه الاجتماعي.
والله خلق الأرض ذلول للإنسان وأمانة استخلاف، وقال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [سورة الملك، الآية 15]، فلفظ «ذلولًا»—كما عند ابن كثير— أي مسخَّرةً لِما فيه معاشُكم، تُقام عليها معايش الناس وتُشق طرقها وتُستخرج خيراتها، لكن الذلول أمانة ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [سورة هود، الآية 61] أي طلب منكم عِمارتها على منهاج الشرع، لا على شهوة الطغيان.
كما أن الله عز وجل خلق الجبال أوتادًا ورواسي، وذكر ذلك في كتابه الكريم ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [سورة النبأ، الآية 7]، ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [سورة النحل، الآية 15]، وفسَّر الطبري: «أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» أي لا تضطرب، و يُقدم القرآن الجبال رموز ثبات في نفس المؤمن؛ ترى ضخامة الخلق فتستحي أن يطيش القلب أو يجزع، ومن هنا كان اعتزال الأنبياء إليها للخلوة والدعاء (انظر اعتكاف موسى عليه السلام بميقات الطور).
وجاء أيضًا في القرآن الكريم عن الطبيعة في القرآن الكريم أن الماء والبحر سرُّ الحياة ومَثَلُ البعث ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [سورة الأنبياء، الآية 30]، وقال أيضًا: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ…﴾ [سورة الزمر، الآية 21] سرد مُحكَم لدورة الماء من إنزال وسُلوك وامتصاص ونَبات.
كما أن تسخير البحر ذُكر في القرآن الكريم ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة النحل، الآية 14]، والتسخير كما يبيَّنه القرطبي نعمة مركبة: رزق، وزينة، ونقل ومعاش، ويذكر الله آية امتزاج المياه واختلافها: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ [سورة الفرقان، الآية 53]؛ ليلفت إلى دقَّة الحدود التي لا يراها إلا أولو النظر.
وذكر الله الماء كمثال للميعاد ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ [سورة الروم، الآية 50]، فيقول ابن كثير: «فكما يحيي الأرض بالمطر بعد قحطها، كذلك يحيي الموتى بعد موتها وتفرقها وتمزقها »، ومشهد الخصب بعد الجفاف ليس نعمة زراعية فقط؛ إنه برهان محسوس على القيامة.
وذكر سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الأنعام، الآية 99]، ثم يسوق تدرُّجًا بديعًا: خَضِرًا—حَبًّا—سُنْبُلًا—قِنْوَانًا—جَنَّاتٍ—زَيْتُونًا—رُمَّانًا؛ ويقول الرازي: هذا التدريج «يعلِّم العقل النظر في مراتب الأسباب»، ويضرب الله بالدنيا مثلَ النبات: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [سورة الكهف، الآية 45]، لتتربِّى النفس على زهد بصير: اعمل وخذ بالأسباب، لكن لا تُؤلِّه الناتج ولا تركن إلى زينة زائلة.
الحيوان والطير ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ [سورة الأنعام، الآية 38] آية من آيات الطبيعة في القرآن يستفاد منها كما نقل القرطبي إثبات النظام في عالم الحيوان، ووجوب الرفق؛ حيث هي أممٌ لها ما يخصَّها من رزقٍ وآجالٍ وتكليفٍ بقدرها، و جاء في الصحيحين: أن امرأة عُذِّبت في هِرّة حبستها، وفيهما كذلك أن رجلاً سقى كلبًا فشكر الله له فغفر له؛ رسائل تربية إيمانية تُعلي حرمة الحياة.
﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ [سورة الإسراء، الآية 12]، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾ [سورة يونس، الآية 5] يربط القرآن بين الفلك والزمن الشرعي مواقيت الصلاة والصوم والحج، والميزان الكوني يتحول إلى ميزان عبادي؛ فالنهار سعيٌ ومعاش، والليل خلوةٌ وبكاء ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا﴾ [سورة المزمل، الآيتين 6–7]).
ونجد الرياح والسحب جنودُ رحمة إذا وُكِّلت، وعذابٌ إذا أُرسلت ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [سورة الروم، الآية 48]، و﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [سورة الحجر، الآية 22]؛ قال ابن كثير: «تلقح الشجر والسحاب»، وفي المقابل: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [سورة الذاريات، الآية 41]، فالريح نعمةٌ إذا أقبلت بأمره، ونقمة إذا جاءت عقوبةً، فتستيقظ القلوب على مقام الخوف والرجاء.
الطبيعة في القرآن الكريم دليل على المعاد
يُكثر القرآن الكريم من القياس الكوني لإثبات البعث بآيات الطبيعة ومنها:
-
إحياء الأرض بعد موتها ﴿وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَحۡيَيۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [سورة فاطر، الآية 9]، ﴿فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ [سورة الروم، الآية 50].
-
ابتداء الخلق أهون من إعادته في ظن الناس، وكلاهما على الله يسير ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [سورة الروم، الآية 27].
-
خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة غافر، الآية 57].
يقول ابن كثير: «من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر»، فمشاهد الطبيعة ليست زينةً فقط؛ إنها حججٌ عقلية.
قوانين وأخلاق البيئة في آيات الطبيعة في القرآن الكريم
- العدل والميزان: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ [سورة الرحمن، الآية 8]، فمن الطغيان البيئي الاستنزاف والإهدار والتلوُّث.
- النهي عن الفساد: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [سورة الأعراف، الآية 56].
- القصد وترك الإسراف: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [سورة الأعراف، الآيات 31]، وقد رُوي في السنن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرَّ بسَعدٍ وَهوَ يتوضَّأُ، فقالَ : “ما هذا السَّرَفُ يا سَعدُ ؟” قالَ : أفي الوضوءِ سَرفٌ قالَ : “نعَم، وإن كنتَ على نَهْرٍ جارٍ”، ومعناه صحيحٌ في فقه السلوك ولو اختلفت طرق إسناده.
- حق الحيوان: أحاديث الصحيحين في الرفق بالحيوان—الهِرّة والكلب—أصولٌ رحيمة.
- غرس الشجرة: في المسند وغيره: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها»، فذلك تربية على العمل حتى آخر لحظة.
- النظافة والطهارة: شطر الإيمان، وهي فقهُ الوقاية البيئية في تفاصيل الوضوء والنجاسة.
- العمران المقاصدي: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [سورة هود، الآية 61] يحمِّل الإنسان تكليف الإصلاح لا امتياز الاستهلاك.
🔹أسئلة شائعة
س: هل يدعو القرآن لدراسة العلوم الطبيعية؟
نعم؛ بدلالة الأمر بالنظر والتفكر: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة يونس، الآية 101]، وبدلالة تسخير الكون للإنسان ﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ﴾ [سورة لقمان، الآية 20]، لكن المقصود علمٌ يورث خشية: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [سورة فاطر، الآية 28].
س: ما موقع «البيئة» في فقه المقاصد؟
حفظُ النفس والنسل والمال والدين لا يتحقق مع فساد البيئة؛ فصيانتها وسيلةٌ لحفظ الضرورات داخلٌ في «لا تُفسدوا» و«الميزان».
س: كيف نفهم وصف الجبال «أوتادًا»؟
حين يصف القرآن الجبال بأنها «أوتاد» (سورة النبأ، الآية 7)، فهو لا يقدِّم درسًا في علم الجيولوجيا، وإنما يقدِّم صورة بليغة تُقرِّب إلى أذهان الناس وظيفتها الكبرى في نظام الأرض، فالوتد معروف عند العرب بأنه جزء ظاهر صغير، وجزء غائر كبير يُثبِّت الخيمة ويمنعها من الاضطراب، وكذلك الجبال ظاهرها نراه شامخًا، وباطنها ممتد في أعماق الأرض، يساهم في توازنها ويمنعها من المَيْد والاضطراب، وهذا ما أشار إليه المفسرون كابن كثير والقرطبي والرازي.
فالمقصود بالآية أن الله جعل الجبال سببًا لاستقرار الأرض وسكناها، فلا تضطرب بالناس ولا تميد بهم، فهي أشبه بالأوتاد للخيمة، أما تفاصيل التكوين والامتداد والطبقات فذلك علم يُترك لأهله من المتخصصين في الجيولوجيا، لكن الدرس الإيماني الذي نأخذه أن هذه الجبال بارتفاعها وثباتها ليست إلا آية من آيات الله على قدرته في الخلق وحكمته في التدبير، لتزداد قلوبنا يقينًا بعظمة الخالق.
س: ما الطريق العملي لتحويل التأمل إلى عبادة؟
ثلاث خطوات: تلاوةٌ متدبرَة لآية كونية، وذكرٌ مناسب (تسبيحٌ أو حمد)، وعملٌ صغير (زرع، ترشيد ماء، رفق بحيوان)، فهكذا تصير الطبيعة سلّمًا إلى الله لا مجرد مشهد.
س: ما هي علاقة الإنسان بالطبيعة من خلال القرآن الكريم؟
علاقة الإنسان بالطبيعة في القرآن الكريم علاقة خلافة وتكريم وابتلاء؛ فالطبيعة خُلقت مسخَّرة له ليستفيد منها ويعمر الأرض: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة، الآية 29]، وهي في الوقت نفسه أمانة ومسؤولية، فلا يجوز إفسادها أو الاعتداء عليها: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [سورة الأعراف، الآية 56]، والطبيعة أيضًا آية من آيات الله تدعو للتفكر والإيمان: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورة آل عمران، الآية 190].
في الختام، تعرفنا على آيات الطبيعة في القرآن الكريم والغرض منها، فإذا أطلقت بصرك في كتاب الله رأيت الطبيعة نصًا موازيًا للمصحف آياتٌ في السطور، وآياتٌ في الوجود، فالسماء تعلمك العلو بلا كِبر، والأرض تواضعًا بلا مَهانة، والجبال ثباتًا بلا قسوة، والبحر سَعةً مع خوف من المجهول، والنبات رجاءً بعد يأس، والحيوان رحمةً وعِشرة، والليل خشوعًا، والنهار سعيًا.
كما أن التدبٌّر ليس ترفًا؛ إنه عبادةُ عقل وقلب وعمل، فإذا قرأت الكون على لسان القرآن، ازددت يقينًا بأن الطريق إلى الله مفروشٌ بآياته: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [سورة الذاريات، الآيتين 20–21]، فلتكن حياتك ترجمانًا لهذه الآيات لا تُفسِد، ولا تُسرف، وازرع، وارحم، واشكر، وتأمَّل.
المصدر